هاجر منصور سراج
13 مايو، 2025
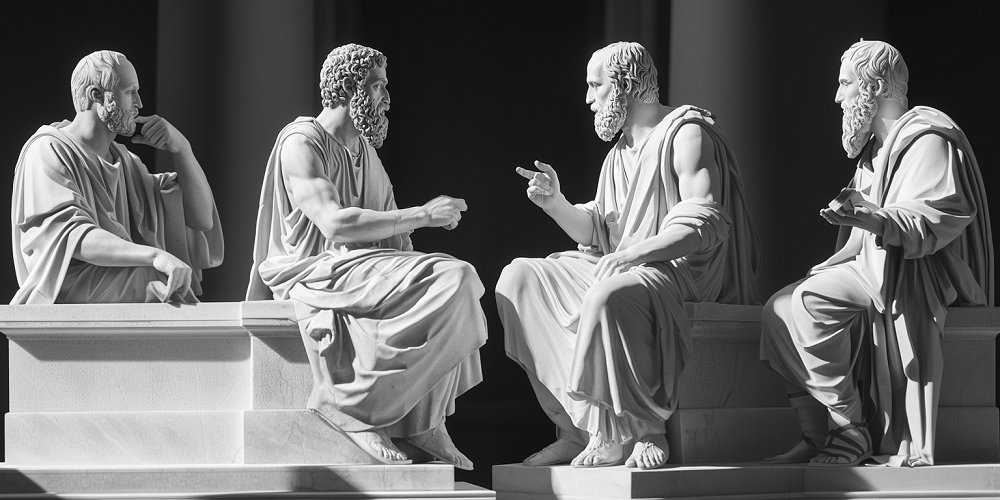
يندرج الأدب تحت مصطلح الفن الذي يتمدد وينكمش تبعًا للمعالجة والرؤية التي ينطلق منها المعالج في طرحه؛ فيسبغ البعض هذه الكلمة على كل عملٍ إبداعي لطيف يتضمَّن عنايةً بشريةً ومهارةً خاصةً، مثل: تنظيم الطاولة، تصفيف الشعر، طبخ الطعام... إلخ. وهم في هذا يقصدون المهارات البشرية في أيِّ سلكٍ، فقد تصدق أيضًا على: فن السياسة، فن الإذاعة، فن الصحافة. وقد اتسع هذا الفن مع تطور الحياة وظهور اهتماماتٍ، وحرف، ومجالاتٍ جديدة. ولم يكن هذا المصطلح في أوَّل أمره محددًا، بل كان أيضًا واسعًا فضفاضًا يقصد به «النشاط الصناعي النافع بصفةٍ عامة» (إبراهيم، 1977، ص8)، فكان يشار به إلى الصناعة، والتجارة، والنجارة... إلخ. ثم جاء أرسطو وقسَّم المعارف البشرية إلى ثلاثة أنواع: معارف نظرية، ومعارف عملية، ومعارف فنية. وكان الفن في مفهومه يعني الشيء الموجود خارج الفاعل، والذي يحقق فيه الفاعل إرادته؛ بينا يجعل غاية العلم العملي الإرادةَ نفسها. ومفهوم أرسطو هذا يقصد به القدرة البشرية بشكلٍ عامٍّ؛ إذ يقصد به ابتداع أشياء جديدة من المواد الخام التي توفِّرها الطبيعة؛ فالإنسان «يحاول عن طريق الفن أن يستخدم الطبيعة. ويضطرها إلى التلاؤم مع حاجته. ويلزمها بالتكيف مع أغراضه» (إبراهيم، 1977، ص9).
وظاهرٌ أنَّ العرب فهموا مصطلح الفن نفس فهم اليونان له؛ فرأوا أنَّه الصناعة التي تستملى من العقل، وتملى على الطبيعة. ثم أصبح مصطلح الفنون يدل على مجموعةٍ من المعارف الإنسانية التي جُعلت تحت اسم كليَّة الفنون في الجامعات الإنجليزية. والفن فلسفيًا «يطلق على ما يساوي الصنعة، ويقابل العلم الذي يعنى خاصةً بالجانب النظري»، كما يعرَّف أيضًا على أنَّه «تعبير خارجي عمَّا يحدث في النفس من بواعث وتأثرات بواسطة الخطوط أو الألوان أو الحركات أو الأصوات أو الألفاظ، ويشمل الفنون المختلفة كالنحت والتصوير» (مجمع اللغة العربية، 1979، ص 140). أمَّا التعريف الأوَّل فهو التعريف القديم، غير المحدد، الذي يشمل الصناعات عامَّةً، وهو ما أصبح شائعًا الآن عند الحديث عن الفنون (المهارات البشرية) المتعلقة بشيءٍ معيَّن؛ وأمَّا التعريف الثاني، فهو ما نقصد إليه عند حديثنا عن الأدب بوصفه فنًّا. والأدب يُدْرَس دراسةً جماليةً تبرز خصائصه وأثره. وهذه الدراسة الجمالية لم تظهر إلَّا على يد أفلاطون. وآراء أفلاطون في الأدب كانت محض آراء داعمةٍ لنظريته السياسية، كما كانت غير ممنهجةٍ بحيث تكوِّن نظريةً خاصةً في الأدب؛ لكنَّها، رغم هذا، دفعت من جاء بعده إلى تأسيس نظرية جمالية سواء بالتركيز على الجمال فحسب أو بمزجه بالأخلاق. فدراسة الجمال تعني العناية بجمال الأشياء دون استهداف أي هدفٍ نفعي أو خيري؛ لأنَّ الفن يتميز عن الأخلاقيات بأنه معنيٌّ بالإنتاج؛ بينا تُعنى الأخلاقيات بالفعل والنشاط ذاته. والأخلاق جزءٌ من الفن، لكنَّها لا تملك أهميَّةً في الفن؛ لأنَّ الفن هو الجوهر الوحيد في العمل الفني. وإذا شئنا تقسيم الفن، فسيكون على قسمين: فنٌّ يستكمل عمل الطبيعة، وفنٌّ يستهدف خلقًا جديدًا. ومثال الأوَّل: الطب، والثاني يتجلى في الفنون الجميلة. (إسماعيل، 1974؛ عويضة، 1995)
في اللغة العربية، تطوَّرت كلمة أدب من المعنى الحسي إلى المعنى المعنوي؛ إذ كانت تأتي في الماضي بمعنى أدب مأدبةً؛ أي أولم وليمةً. ثم تضمَّنت دلالة التربية والتخلُّق بالأخلاق الحميدة، ثم التعليم ورواية الشعر، ثم الشعر والنثر وما يتصل بهما. وهذا الأخير هو المعنى الخاص، أمَّا المعنى العام فيطلق على المعارف والآثار الإنسانية، مثل: أدب الحديث، أدب النديم، أدب مجالسة الملوك (التونجي، 1999، ص47). وقد جاء في لسان العرب، في مادة (أ د ب): الأدبُ الذي يتأدَّب به الأديب من الناس؛ وسمي أدبًا لأنه يَأْدِبُ النَّاس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. وأصل الأدب الدعاء، ومنه قيل للصنيع يُدعى إليه الناس: مَدْعاةٌ ومأدبةٌ. وتحت معنى التربية والرياضة، جاء: فلان قد استأدبَ بمعنى تأدَّب. ويقال للبعير إذا رِيضَ وذُلِّلَ: أديبٌ مؤدَّب. ويطلق على الأخلاق، والظّرْف، وحسن التناول؛ فنقول هو أديب، والقوم أدباء.
أمَّا من حيث الاصطلاح، فتكثر التعاريف وتختلف تبعًا لرؤية ومنهج الواضع وفلسفته؛ فيرى فيه البعض كل «ما عبَّر عن معنى من معاني الحياة بأسلوب جميل»، ويرى فيه البعض: «الكلام الذي ينقل إلى السامع أو القارئ التجاربَ والانفعالاتِ النفسية، التي يشعر بها المتكلم أو المنتج» (التنوجي، 1999، ص47). ويرى فيه البعض: «كل ما أنتجه البشر مخطوطًا أو مطبوعًا»، و «مجموع الآثار النثرية والشعرية التي تتميز بسمو الأسلوب وخلود الفكرة الخاصة بلغةٍ ما أو بشعب معين» (مجدي وهبة، 1974، ص291).
جاء في لسان العرب، في مادة (ن ظ ر): النظر: الفكر في الشيء تُقدِّره وتقيسه منك. وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: «النظرية: قضية تثبت صحَّتها بحجة ودليل أو برهان (نظرية محاكاة الحيوان)»، وهي أيضًا: «بعض الفروض أو المفاهيم المبنية على الحقائق والملاحظات تحاول توضيح ظاهرة معينة (نظرية الذرَّة)»، وهي أيضًا: «مجموعة المسلمات التي تُفسِّر الفروض العلمية أو الفنية (نظرية ابن خلدون في علم الاجتماع)» (عمر، 2008، ص2233). وهي في معجم مصطلحات الأدب: «جملة تصوُّرات مؤلَّفة تأليفًا عقليًا تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات»، وهي أيضًا: «فرض علمي يمثِّل الحالة الراهنة للعلم، ويُشير إلى النتيجة التي تنتهي عندها جهود العلماء أجمعين في حِقبة معيَّنة من الزمن» (وهبة، 1974، ص 569).
ومجال نظرية الأدب، هو أحد الفنون الأدبية النقدية الحديثة التي تدرس أصول الأدب وفنونه ومذاهبه، وتضع القواعد المناسبة لدراسة الأدب، وتعالج المفاهيم الجمالية. وتختلف عن النقد في أنها تقنن الأسس النظرية لدراسة الأدب ولا تقوم بدراسة النصوص الأدبية. (التنوجي، 1999)
جاء في لسان العرب، في مادة (ح ك ي): المحاكاة المشابهة، فيقال فلانٌ يحْكي الشمس حسنًا ويحاكيها. وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: حاكى فلانًا: شابهه في القول أو الفعل أو غيرهما. وحاكى الغربَ: قَّلَّده. (عمر، 2008). وبحسب علم النفس، هي: «إعادة لحركات وأعمال تحت تأثير موقف معين، وهذه هي المحاكاة الغريزية، وتلحظ لدى الإنسان والحيوان، أو تقليد مقصود لحركات وأفعال جديدة، وهذه هي المحاكاة الشعورية، ويختص بها الإنسان» (مجمع اللغة العربية، 1979، ص171).
أمَّا المحاكاة أدبيًّا، فهي مصطلح يوناني جاء به أفلاطون وأرساه أرسطو في كتابه (فن الشعر) حين ردَّ فيه على آراء أستاذه أفلاطون التي أوردها في كتابه (الجمهورية)، في الكتاب العاشر. ونظرية المحاكاة التي قال بها ذان الفيلسوفان هي موضوع المقالة، وسأتناول ذين الفيلسوفين بالتعريف أوَّلًا قبل أن أنتقل إلى آرائهما في الشعر.
هو أسطوكليس (أي الأحسن الشهير)، وقد لقُّب بأفلاطون لامتلاء جسمه وقوَّة بنيته. ولد عام 427 ق.م تقريبًا لعائلة أرستقراطية يرجع أصلها من جهة أبيه إلى آخر ملوك أثينا الأقدمين، ومن جهة أمة إلى المشرع اليوناني العظيم صولون. في العشرين من عمره اختلف إلى سقراط واستمع إلى أسئلته ومحاوراته التي زعزعت مفاهيم الثوابت الراسخة في عقله وغيَّرت في رؤيته للعالم حوله، هو وشباب آخرين. ولمَّا حُكِم على سقراط بالإعدام بتهمة إفساد عقول الشباب والتطاول على الآلهة، حاول أفلاطون إخراج أستاذه من السجن، وألح عليه ليهرب؛ لكن سقراط رفض وواجه مصيره، فغادر أفلاطون أثينا إثر ذلك مثقلًا برغبةٍ في تغيير أثينا وإصلاح وضع السياسة. بعدها، تنقَّل أفلاطون بين إيطاليا وصقلية، ومصر فلسطين اثني عشر عامًا. ولمَّا عاد إلى أثينا، أسس مدرسة الفلاسفة التي سمَّاها (الأكاديمية)، وسخَّر حياته لتدوين أفكار أستاذه القائمة على فكرة العدل. (الميناوي، 2010؛ الحسن، 2009؛ شمس الدين، 1990)
تقوم فلسفة أفلاطون بشكلٍ عام على فكرة العقل، قائلًا بأنه القوة القادرة على كشف المفهوم والنظام اللَّذين يحكمان العالم المتغير، وبأنه القادر على خلق انسجام بين الحكومة والشعب، ما سيفضي إلى حياة سعيدة. ولا تقوم الحياة السعيدة، من وجهة نظره، إلَّا حين يُحكِّم الإنسان عقله في أموره كلِّها، ولا يسلِّم ذلك إلى العاطفة. ومن أساس العقل انبثقت نظريته في الأدب (نظرية المحاكاة). وقد تناول الشعر بالنقد لتأكيد قضية تحكيم العقل وإقامة العدل؛ ذلك أنَّه رأى أنّ الفن بصورةٍ عامة، والشعر بصورة خاصة، له تأثير سيءٌ في الطبيعة الإنسانية لثلاثة أسباب: الأوَّل أنَّ الشاعر يفقد شخصيته في خضم تعبيره عن أشخاصٍ آخرين، ما يجعله قابلًا لاكتساب الشرِّ بسبب حديثه عن الأشرار وتسويغه أعمالهم. والسبب الثاني أنَّ الشعراء لا ينفكون يصفون الآلهة بصفات الكسل، والغيرة، واللهو؛ وهو ما كان أفلاطون يرفضه ويسعى إلى ترسيخ صورة مثالية للآلهة في عقول النشء الذين هم أساس بناء الدولة المستقبلية، والذين يجب أن يحظوا بتربية رصينة تمكِّنهم من قيادة الدولة بعد نضوجهم؛ فالشعراء آنذاك كانوا يعدُّون سلطةً عليا تشكل السلوكيات والأخلاق، وكانوا يُعَدُّون مُعَلِّمين رسميين، فإذا كان كلامهم محض خزعبلات في نظر أفلاطون، فإنَّ أشعارهم لن تقوم إلَّا بإضعاف النشء؛ وهذا هو السبب الثالث الذي يجعل الشعر غير ذي فائدةٍ في المدينة الفاضلة؛ بل يمكن أن يُخِلَّ بنظام الدولة وينشر الضعف بين سكَّانها. وكي يقنعنا أفلاطون بعبثية الشعر وانعدام قيمته، فصَّل القول في ماهية الشعر، ومصدره، ووظيفته. (الماضي، 1993؛ شعراوي، 1999؛ القلماوي، 1953)
الأدب بحسب نظرية المحاكاة عند أفلاطون يُعالج على ثلاثة أركان: الماهية، المصدر، الوظيفة. وهذه الأركان هي ما عالجها دارسو نظرية الأدب في النظريات الأدبية كلِّها، وهي ما تحدد قيمة الأدب. وقد صنِّفت أفكاره هذه تحت مفهوم نظرية المحاكاة، وهي: «الترديد الحرفي لموضوعات التجربة المعتادة وما يتكشف عنه الموضوع الفني يشبه بدقةٍ ذلك الأنموذج الموجود خارج العمل الفني الذي يحاكيه» (الحسن، 2009، ص21). فالشاعر، عند أفلاطون، يحاكي المحسوسات التي تملك صورةً حقيقيةً معقولةً لا تدرك بالبصر، وإنما هي موجودة في عالم المثل. وعالم المثل هو «عالم الأفكار المجردة الثابتة والأزلية (...) لا توجد في ذهن الإنسان فقط وإنما وجودها الحقيقي هو وجود موضوعي مفارق، في عالمها الخاص». والمحسوسات في الواقع (كالكرسي مثلًا) هي محاكاة، ومجرَّد صورة مشوهة من الصورة المثالية، فيكون الشاعر هنا، بتصويره الكرسي المحسوس، مقلِّدًا لصورةٍ زائفةٍ مشوهة. وبهذا تكون ماهية الشعر محض تقليد زائف ناقص، و(محاكاة للمحاكاة).
والفنان، إلى هذا، عاجز عن الخلق. فهو يصور الكرسي غيرَ قادرٍ على صنعه. ويضرب أفلاطون لهذا مثلًا بدرع آخيل التي صوَّرها هوميريوس، فيقول إنَّ هوميريوس لا يدري عن هذه الدرع شيئًا، ولم يرَها، ولا يستطيع صنعها؛ وإنما هو يحاكي دون أن يفهم سرَّ الصنعة. وليس هذا على مستوى تصوير الأشياء فحسب، بل على مستوى تصوير التقاء الجيوش أيضًا، أو عبور البحر، أو مجابهة الوحوش. لا يعلم الشاعر عن هذا شيئًا؛ لكنه يتصدَّى لتصويره ويفصِّل القول فيه حتى يقنع الناس بحقيقته وهو غير حقيقة. وهذه الحقيقة المزورة هي ما تجعل أفلاطون ينتقص الشعراء ويطردهم من مدينته. (القلماوي، 1953؛ الماضي، 1993؛ الميناوي، 2010)
أمَّا من ناحية المصدر، فيرى أفلاطون أنَّ الشعراء إنمَّا توحي إليهم الآلهة قول الشعر. وهذا ما كان شائعًا قديمًا؛ فالشاعر يقذف ما يتلقَّاه من آلهة الشعر، وليس له يدٌ في هذا، فهو غير قادرٌ على كبحه ولا على تحويره، كما هو عاجز عن الابتكار حتَّى يُلهم، وحينها لا يملك قدرةً على الإحساس أو التفكير. وإذ يعترف أفلاطون بهذا، يرى أنَّ الشعراء معذورون في الفساد الذي يسببونه، وهو لا يلومهم، لكنه لا يستطيع أن يتهاون معهم؛ إذ يتبدون له محض أفواه مفسدة لا يمكن السيطرة عليها؛ ولذا يخلص أفلاطون إلى حلِّ طرد الشعراء من مدينته؛ لأنَّ مصدرًا غيبيًا يتحكم بهم وليس العقل. وتحكيم العقل في منهج أفلاطون هو ما يدفعه إلى التشكيك في كل شيء يلمس العاطفة أو يتحكم بها، وهذا ما يقوم الشعر به، ويندرج هذا تحت وظيفة الأدب. (القلماوي، 1953؛ الماضي، 1993؛ هلال، 1997)
يرى أفلاطون أنَّ الشعر يقصد إلى إثارة العواطف والمشاعر، وهو الذي يحاول إغفالها ودفنها حتى يُشيِّد مدينةً تسير على نظامٍ تامٍّ لا يفسده شيء. فأفلاطون يرى العاطفة محض حافز إفساد، ولا يعنيه خطاب النفس، بل يعنيه النظام والتوازن. وإذ يتوجه الشعراء نحو العاطفة يأججونها ويسعرونها ويضعفون بها دولته ويجعلون الناس أكثر ضعفًا واستسلامًا للعواطف، يقرر أفلاطون أنَّهم مخلُّون بنظام دولته، فيطردهم لهذا السبب؛ لكنَّ أفلاطون يخشى الإساءة إلى ربة الشعر، فيترك الشعراء في مدينته تحت شروط محددة هي: الالتزام بالقصائد التي تمدح الأبطال، والآلهة، والمشاهير؛ وعدم كتابة قصيدة تتعارض مع الخير والشرعي؛ وإطلاع القضاة وحراس القوانين على القصائد قبل نشرها بين الناس. (القلماوي، 1953؛ الماضي، 1993)
من هذا يتضح لنا أنَّ أفلاطون هاجم الشعر انطلاقًا من النقد الجمالي تارةً، ومن النقد الأخلاقي تارةً أخرى. وهو في هذا كلِّه إنما يسعى إلى رفع شأن الفلاسفة في مقابل الشعراء الذين كان يُحتفى بهم في عصره. وسعيه هذا إنما هو جزء من سعيه إلى معارضة كل المظاهر السياسية، والاجتماعية، والثقافية السائدة في عصره سعيًا نحو تأسيس دولةٍ جديدة تقوم على مبدأ العدل والنظام. فتحامل أفلاطون على الشعر إنما هو مظهر من مظاهر سعيه الدؤوب إلى تأسيس العلم والمعرفة الحقيقية، وتأسيس مبدأ الخير والفضيلة. وإقصاؤه الشعراء من مدينته إنما هو إقصاء كل ما ليس له نفع أو فائدة، بحسب رأيه. ورأيه هذا لا يقتصر على الشعر فقط؛ إذ من ضمن هذا التخلص من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أيِّ طبقةٍ كانوا؛ لأنهم لا يقدمون أيَّ فائدة للمجتمع. (الحسن، 2009)
ولأن للشعر قيمةً كبيرةً عند اليونان على المستوى الاجتماعي، والأخلاقي، والجمالي؛ ولأن تذوق الشعر لا يتطلب ثقافةً عاليةً أو مزايا خاصة؛ تعرَّض أرسطو (تلميذ أفلاطون) لنظرية المحاكاة معارضًا آراء أستاذه بأدلة وبراهين عقلية بعيدًا عن المثالية والغيبية التي جاء بها أفلاطون.
ولد أرسطو عام 385 ق.م تقريبًا، في إستاجيرا لعائلة تتوارث مهنة الطب، وقد كان والده طبيب بلاط ملك مقدونيا. وفي سنِّ الثامنة عشرة، انتقل أرسطو إلى أثينا ليتلقى التعليم العالي في أكاديمية أفلاطون، وهناك رأى فيه أستاذه النجابة والحصافة ما دفعه إلى تبنِّيه. وبعد وفاة أفلاطون، انتقل أرسطو مع أحد زملائه في الأكاديمية للعيش في آسيا الصغرى، وهناك تزوَّج أرسطو أخت زميله. ويظهر أنَّه كان زواجًا سعيدًا حتَّى قتل زميله، فعاد أرسطو إلى مقدونيا، وعمل معلمًا لابن الملك المقدوني، الذي أصبح بعد ذلك الإسكندر المقدوني. وبعد تولَّى الإسكندر العرش، عاد أرسطو إلى أثينا وأسس مدرسةً منافسةً للأكاديمية سُميت بالمشائية؛ لعادة أرسطو في المشي أثناء إلقاء الدروس. وفي هذه المدرسة ألَّف أرسطو الكثير من المحاضرات في العلم والفلسفة. (عبد المعطي، 1992)
في البداية، انطلق أرسطو في معارضة آراء أستاذه أفلاطون من حصر المحاكاة في الفنون الجميلة والفنون النفعية (كالنجارة)؛ أمَّا الموجودات في الواقع فليستْ محاكاةً للموجودات في عالم المثل، كما قال أفلاطون. وعارض أرسطو أستاذه في أنَّ الفنون الجميلة ليست أقلَّ مرتبةً من العلم، بل يجعل المحاكاة أعظم من الحقيقة والواقع انطلاقًا من أنَّ محاكاتها للطبيعة تساعد الإنسان على فهم الطبيعة؛ لأنَّها محاكاة لجوهر الطبيعة وإكمالها، وإيضاح أغراضها. والفن بهذه الخاصة وسيلة تربوية وتهذيبية. (هلال، 1997)
ويشرح هذا أنَّ الفنون الجميلة (الموسيقا، والرقص، والتمثيل، والشعر) تحاكي الأخلاق، والوجدان، والأفعال وليس المظاهر الجامدة. فالفنان يستخدم موادًا طبيعية لمحاكاة شيء معيِّن، لكنَّ هذه المحاكاة لا تحاكي الشيء أو الشخص، بل الموضوع. والشاعر يحاكي مواضيع مختلفةً، يحاكي الناس (وهم يفعلون) خيرًا أو شرًّا، مستخدمًا مادة (الكلمات المنطوقة). والأشخاص في الدراما الشعرية ليسوا محاكاةً للأشخاص في الواقع؛ بل يأتون إمَّا أسمى أو أحط، وبهذا تتميز الفنون في محاكاتها بالموضوع، والمادة، والأسلوب، فلا تشبه بهذا المحاكاة العادية. علاوةً على أنَّ المحاكاة في الفنون الجميلة ليست نقلًا وتقليدًا، بل تحوي تغييرًا وإضافات خاصة يقوم بها الفنان. كما أنَّها ليست فقط للأمور التي وقعت، بل هي أيضًا محاكاة ما يمكن أن يقع، وهو مجال فيه خلق فني وتوجيه اجتماعي يميِّز الشاعر عن المؤرخ وعن الفيلسوف. وأرسطو هنا يعني عنصر الخيال، لكنه لم يذكر أيَّ لفظٍ يدل عليه. إذن، يتضح لنا أنَّ ماهية الأدب بحسب نظرية المحاكاة عند أرسطو هي محاكاة انفعالات الناس وتصوراتهم الذهنية من خلال أفعالهم. (هلال، 1997؛ حماده، 1983؛ إبراهيم، 2001؛ عويضة، 1995؛ القلماوي، 1953)
ويعارض أرسطو أفلاطون في قوله إنَّ مصدر الشعر هو الإلهام وربَّة الشعر، فيرجع ذلك إلى غريزة المحاكاة وحبِّ النغم والوزن، والتي يراها شيئًا أصيلًا في الإنسان، تظهر منذ الطفولة، وبها يكتسب الإنسان معارفه. فالإنسان، عنده، محاكٍ بطبعه، وهو يبتهج برؤية المحاكيات. ويرى أرسطو أنَّ محاكاة الأفعال النبيلة أنشأت المدائح والترنيمات، ومحاكاة الطبائع الخسيسة أنشأت الأهاجي. وحين ظهرت الدراما، انصرف الشعراء الجادون عن نظم الملاحم إلى كتابة التراجيديات، وانصرف الشعراء الهازلون عن نظم الأهاجي إلى كتابة الكوميديات. الشعر، إذن، عند أرسطو هو محاكاة للأفعال يستعان فيه باللحن والإيقاع؛ والمحاكاة وحب اللحن غريزةٌ بشريةٌ لا وحي. (حماده، 1983؛ هلال، 1997؛ القلماوي، 1953)
وافق أرسطو أفلاطون في أنَّ التراجيديا تثير عاطفتي الخوف والشفقة عند الناس؛ لكنَّه خالفه في أنَّ لإثارة تين العاطفتين وظيفةً إيجابيةً لا سلبيةً؛ لأنَّ إثارتهما تؤدي إلى التطهير Catharsis. فأرسطو يرى أنَّ «النفس لا تضطرب بأمثال هذه الأغاني إلا لتهدأ في عاقبة الأمر، كأنها صادفت طبًا وتطهيرًا» (هلال، 1997، 80). والتطهير في التراجيديا يحمل معنى دينيًّا ومغزًى أخلاقيًا، وهو علاجٌ للنفس يتجلى عند رؤية المُشاهِد شخصيات التراجيديا وأقدارها تتقلب بين سعادة وشقاء؛ فيثير هذا في نفس المُشَاهِد الخوفَ والشفقةَ؛ الخوف من الوقوع في المصير نفسه، والشفقة على البطل الذي لا يستحق ما آل إليه حاله. وبهذا تشفى نفس الإنسان من الشرور والرغبات الغريزية، وتزرع في النفس ترددًا في ارتكاب الآثام خوف الوقوع في المصير نفسه. والمأساة تزيد معرفة الإنسان بالطبيعة البشرية عامةً عن طريق إيهام المشاهد أنَّ ما ترويه حدث فعلًا. وفي الكوميديا، يثير الهزل ضحك الناس، وبهذا يتطهَّرون من العواطف الأخرى. (إبراهيم، 2001؛ خليل، 2003)
من هذا يظهر لنا أنَّ الأدب بحسب نظرية المحاكاة عند أرسطو هو محاكاة إيجابية على مستوى الإنتاج والتأثر، ورأيه هذا جاء من تحليله للشعر طبقًا لمنهج الاستقراء، فدرس الإنتاج الشعري في الواقع، وراقب تأثر الناس به، وشغف الناس باللحن والمحاكاة، ثم جاء بآرائه الفلسفية؛ بينا انطلق أفلاطون في آرائه من التأمُّل ومن أساس أخلاقي بحت؛ فكتاب الجمهورية يُعنى، بشكل أساسي، بفلسفة التربية، ويحاول فيه أن يصل إلى أسس تؤدي إلى حياةٍ حسنة خيِّرة عن طريق إقامة العدل والصلاح في المجتمع، وهو ما سينتج لنا، بحسب تطلعاته، الكائن الإنساني الخيِّر. وكتاب الجمهورية وُضع في الأصل لمناقشة سياسة الدولة حتَّى اتفق المعلُّقون على الكتاب أنَّ الباب العاشر (الذي تناول فيه أفلاطون الشعر) إنما هو ملحق غرضه تجديد الهجوم على الشعر؛ لكنَّ أيما استهجان للشعر لا يظهر في لغة أفلاطون، وإنَّما إقصاؤه الشعر والشعراء من مدينته إنما هو انطلاق من مبدأ العدل، والصلاح، والنفعية. فأفلاطون نفسه متذوِّق للشعر، والأسلوب الذي كتبت به محاوراته ينبئ عن شاعر؛ لكنَّه قدَّم الفلسفة على الشعر لتمييز الفلاسفة وإعلانهم معلمين بدلًا من الشعراء، ولإبراز دور الشعر في بناء الدولة. (خشبة، 2012)
وإذا شئنا معرفة سبب اهتمام أفلاطون بقيمتي العدل والخير، فحريٌ بنا أن نعود إلى حياته لاستطلاع الأمور التي حدثت في أثينا إبَّان عيشه، والتي ساهمت في تشكيل شخصيته وفكره؛ فقد عاش في زمنٍ شاعت فيه الثورات، والاتجاهات المعارضة، والحروب حتَّى وقعت أثينا في يد فيليب المقدوني. وقد رأى أفلاطون أنَّ سبب سقوط أثينا واضطرابها إنما عائد إلى الحكَّام الذين لم يتخذوا أسلوبًا عقلانيًا في الحكم، فالعدل عنده إنما هو وليد العقل. ومن هنا انطلق إلى وضع آرائه الفلسفية في الجمهورية، ورفع الفلاسفة على البشر جميعًا قائلًا إن الحاكم يجب أن يكون فيلسوفًا حتى يكون حاكمًا جيِّدًا. وهذا التوجه الأخلاقي الإصلاحي في تناول الشعر يغفل قيمة الشعر الجمالية؛ وإن كان أفلاطون، في حقيقة الأمر، ذا نزعةٍ مثاليةٍ في فهم الجمال؛ إذ اعتدَّ بالجمال وجعله مثاليًا لا يمكن للبشر أن يطالوه إلَّا عن طريق المحاكاة المزيفة للموجودات. (خشبة، 2012؛ إسماعيل، 1974)
ورغم أنَّ أفلاطون انطلق من مذهب التأمل، وأرسطو من منهج الاستقراء؛ حاول كلاهما الإجابة عن سؤال: ما علاقة الشعر بالواقع. وأجاب كلاهما أنَّ الشعر محاكاة، ثم اختلف مفهوم المصطلح عندهما. فأرسطو قد تأثَّر بعلم الحياة الذي درسه من بداية حياته، وأساس هذا راجع إلى أنَّه نشأ في أسرةٍ تتوارث مهنة الطب، فنشأ على استطلاع الموجودات، واستكشاف الدوافع الفكرية عند الإنسان، ومراقبة الطبيعة بحسب معطياتها الظاهرة لا الغيبية؛ أي الاستقراء، وهو ما كان يسميِّه أرسطو (الانتقال من الوقائع الفردية إلى الكليات)، وقد أكَّد أرسطو على أنَّ «النتيجة لا تعتبر مبرهنًا عليها إلا إذا فحصت سائر الأفراد في الحالة التي تكون موضع استقراء» (عبد المعطي، 1992، 33). وعناية أرسطو بهذه الطريقة في وضع الآراء، جعل الفلاسفة من بعده يعتدُّون بمنهج الاستقراء في وضع كتبهم.
وآراء أفلاطون في بساطتها وتوجهها لا تشكل نظريةً مكتملة الملامح، فهي بهذا آراء نقدية فحسب؛ بينا يمكن وصف آراء أرسطو بالنظرية نظرًا لتفصيله القول في التراجيديا والكوميديا: أركانها، وأحوال شخصياتها، وتسلسل أحداثها، والأثر الذي تحدثه في المتلقي (الأثر الناتج لا المباشر)، علاوةً على توفير أمثلةٍ تطبيقية. وهذه الدراسة المنهجية جعلتْ بعض آرائه صالحةً للدراسة والتطبيق حتى يومنا هذا.
نخلص من هذه المقالة أنَّ هذه الآراء النقدية، التي نشأت قبل الميلاد، تناولت سؤالين، الأوَّل: ما علاقة الشعر بالواقع؟ هل هو محاكاة أم أنه إبداع؟ والثاني: ما علاقة الشعر بالمتلقي؟ هل هو إمتاع، أم تطهير، أم شيء آخر؟ وذان السؤالان الرئيسيان هما ما انطلق منهما شعراء القرن التاسع عشر عند ظهور الأدب الرومانسي لتحديد نظرية التعبير.
المصادر والمراجع
(1) أرسطو أستاذ فلاسفة اليونان، فاروق عبد المعطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1992.
(2) أفلاطون سيرته وفلسفته، أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1990.
(3) أفلاطون قراءة جديدة، داود روفائيل خشبة، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2012.
(4) الأسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة، عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، 1974.
(5) الجمهورية - المدينة الفاضلة، أفلاطون، ت: عيسى الحسن، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2009.
(6) المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1979.
(7) المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الثانية، 1999.
(8) النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، إبراهيم محمود خليل، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة الرابعة، 2011.
(9) النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1997.
(10) النقد الأدبي عند الإغريق والرومان، عبد المعطي شعراوي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1999.
(11) جمهورية أفلاطون، أحمد الميناوي، دار الكتاب العربي، دمشق - القاهرة، الطبعة الأولى، 2010.
(12) حصاد الفكر الفلسفي اليوناني، كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 1995.
(13) فن الأدب - المحاكاة، سهير القلماوي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى، 1953.
(14) في نظرية الأدب، شكري عزيز الماضي، دار المنتخب العربي، لبنان، الطبعة الأولى، 1993.
(15) كتاب أرسطو فن الشعر، إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1983.
(16) مشكلة الفن، زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، 1977.
(17) معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 2008.
(18) معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبة، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 1974.
(19) نظرية الدراما الإغريقية، محمد حمدي إبراهيم، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، القاهرة، الطبعة الأولى، 1994.